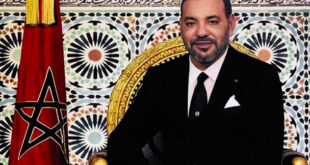رصد عبد الله ساعف، الوزير الأسبق وأستاذ علم السياسة بجامعة محمد الخامس، التحولات التي شهدها القانون في المغرب نحو نمط قانوني عقلاني حداثي، يعكس تزايد النزوع داخل المجتمع نحو الفردانية والعقلانية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن إصلاح المجتمع لا يمكن أن يتم عن طريق القانون وحده.
وأشار عبد الله ساعف، خلال ندوة حول مكانة القانون في النظام السياسي المغربي، بكلية العلوم القانونية بالجديدة، إلى أن المغرب، منذ الاستقلال، يشهد انتقالًا تدريجيًا من نمط المشروعية التقليدية أو الكاريزمية نحو مشروعية عقلانية قانونية ذات طابع حداثي.
وأشار ساعف إلى تطور القانون المغربي عبر ثلاث مراحل محورية، تميزت الأولى ببنية قانونية محدودة، متأثرة بإرث الدولة التقليدية وما خلفته الدولة الكولونيالية من مؤسسات وتشريعات. في هذه المرحلة، كان من السهل الإلمام بمجمل القوانين، بالنظر إلى قلة النصوص القانونية وتواضع التخصصات.
وفي مرحلة الثمانينات، يشير ساعف إلى أن التقويم الهيكلي كان محطة مركزية في إعادة صياغة القوانين، خاصة في المجال الاقتصادي. وقد فرضت هذه المرحلة اعتماد مبادئ الترشيد والعقلنة، والبحث عن توازنات كبرى، ما أدى إلى إنتاج عدد كبير من القوانين الجديدة، واستبدال أسس العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت قائمة.
ثم موجة أخرى من تطور القانون المغربي ما بعد 1995 مع توقيع اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي أسفرت عن موجة قوية من الإصلاحات القانونية في مختلف المجالات، من القضاء إلى التجارة والقطاع البنكي.
ويؤكد الأكاديمي المغربي أنه جاءت موجة جديدة من السياسات العمومية، مرتبطة بـ”التناوب”، منها ما تعلق بالحريات العامة، والوظيفة العمومية، والميثاق الجماعي، وانطلاقة ورش الإعلام السمعي البصري وغيرها من النماذج، ثم جاء دستور 2011، الذي نص على إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية.
وأوضح “عندما نعود إلى المنتوج التشريعي خلال الولاية الحكومية التي امتدت من 2012 إلى 2016، برئاسة عبد الإله بنكيران، نجد أن عدد مشاريع القوانين بلغ 390. بينما المعدل في الولايات الأخيرة لا يتجاوز 240 أو 250. وهذا يعكس وجود موجة قوية من الإنتاج القانوني آنذاك، والتي يمكننا ربطها بإطار مرجعي معين”.
ويستحضر دينامية الإحصاء الأخير، الذي حدّد عدد سكان المغرب في 37 مليون نسمة على الأقل، متسائلا: “ما الذي يمكن أن يُغيره هذا الرقم في السياسات العمومية؟، مضيفا “هناك تأثير واضح لهذه المعطيات الديموغرافية الجديدة على التشريعات، وعلى السياسات العمومية التي ستُبلور خلال العشر سنوات المقبلة، وهو ما تعكسه المؤشرات الأولى التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، حيث يظهر أن تحت سماء المغرب، هناك تحولات جديدة تختلف عن سابقاتها”.
وأضاف “لا ننسى أيضًا الأحداث غير المتوقعة، أو ما يسمى قانونيًا بـ”التشريع الطارئ”، الذي يُفرض بسبب ظروف استثنائية. خذوا مثلًا الزلزال الأخير، وما ترتب عنه من نصوص تشريعية جديدة في الجريدة الرسمية. كل من يتتبع الجريدة الرسمية سيلاحظ أن جهة الحوز، على سبيل المثال، أصبحت محورًا لعدة مستجدات تشريعية”.
وأشار إلى أنه تم التوجه إلى عدة قوانين إطار، عكس السابق، إذ يمكن الحديث عن ستة منها على الأقل في مجالات مختلفة، منها قانون إطار لإصلاح النظام الضريبي، وقانون إطار في مجال التربية والتعليم، وقانون إطار في مجال الحماية الاجتماعية، بالتالي، من السهل ملاحظة أن هناك توجهًا واضحًا نحو اعتماد قوانين الإطار. وهذا ما نعتبره الآن معطىً جديدًا وأساسيًا في إنتاج القانون”.
القانون وإصلاح المجتمع
وأوضح أنه كان هنا “إدراك بأن القانون لا يكفي أن يُنص عليه نظريًا، بل يجب العمل على ضمان تطبيقه. غير أن السوسيولوجيا القانونية تُظهر لنا دائمًا أن هناك مسافة فاصلة، في كل المجتمعات، بين النص القانوني وبين تأثيره الواقعي. فالطريقة التي يتحدث بها القانون عن ظاهرة اجتماعية ما، قد تختلف كثيرًا عما يتحقق على أرض الواقع. عند تنزيل القانون، قد لا تُحترم نية المشرّع أو الأهداف التي كان يسعى إليها”.
وتابع ساعف أنه “في المجالات الحقوقية، هناك دائمًا من يتمنى أن يتم تطبيق ما ينص عليه القانون بحذافيره. وأنا شخصيًا لدي تحفظ على هذا الاعتقاد، رغم وجاهته. لأن النوايا شيء، والقدرة على تحقيقها شيء آخر. تطبيق النص القانوني أمر معقد ويصطدم بعوائق متعددة”.
الجسم القانوني المغربي، بحسب ساعف، ليس موحدًا، بل يتكون من ثلاثة أنظمة على الأقل، منها القانون العرفي: وهو القانون الذي يتجلى في ممارسات محلية وتقاليد اجتماعية تختلف من منطقة إلى أخرى. والشريعة الإسلامية: وهي المكون الثاني، وقد شكلت الأساس التشريعي لقرون. وعلال الفاسي، في كتابه حول الشريعة، أكّد على صلاحيتها لكل زمان ومكان، واعتبرها المرجع الأساسي للتشريع المغربي. ثم القانون الرأسمالي الحديث: وهو الذي جاء به الاستعمار الفرنسي، واستمر العمل به حتى بعد الاستقلال، خصوصًا في المجال الاقتصادي والمؤسساتي، ويُسمى أحيانًا “القانون الوضعي” أو “القانون الحديث”.
وأوضح أن القانون المغربي لم يعد نظامًا ثلاثيًا فقط، بل أصبح منظومة هجينة، تتشكل من ترسبات وتداخلات متراكمة، تشبه طبقات جيولوجية، كل طبقة فوق الأخرى، فتجد عناصر من القانون الحديث وقد تسربت إلى تطبيقات العرف، أو تجد ممارسات تقليدية يتم تأطيرها بنصوص حديثة.
ويخلص ساعف إلى أن أن الجواب عن السؤال الجوهري: هل يمكن إصلاح المجتمع فقط عن طريق القانون؟ هو: لا، القانون وحده لا يكفي. مضيفا “نعم، يمكن للقانون أن يكون وسيلة للإصلاح، وله دور إصلاحي واضح، وقدرة على التأثير وتغيير الأوضاع. لكن دائمًا، هناك مسافة بين النص والتطبيق. وعلى الباحثين في القانون ودلالاته أن يتساءلوا: لماذا تحدث هذه المسافة؟ ولماذا يصعب أحيانًا تجسيد القانون في الواقع؟”.
ويردف ساعف “أسباب تعثر تطبيق القانون متعددة، ومتشابكة، ومتغيرة حسب السياق. وبالتالي، فالمناضلون الحقوقيون الذين يرون في القانون مدخلًا للتغيير الاجتماعي، عليهم أن يُدركوا أن القانون يُمكن أن يُساهم في الإصلاح، ولكن لا يمكن أن يقوم به وحده، بل يجب أن يُرافقه فعل سياسي، وتعبئة اجتماعية، وإرادة تنفيذية واضحة”.
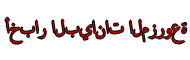 أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.