ماذا لو كانت الحكايات الأكثر عمقا في الروايات لا تُروى في صلب الأحداث، بل تُهمَس في هوامش السرد المعتمة، وتتوارى خلف صمت الشخصيات، وتتسلل عبر التوترات الخفية للغة؟ ماذا لو كانت وظيفة النقد ليست مجرد تحليل ما هو ظاهر، بل الحفر في هذه المناطق التي احتضنت الصراعات المؤجلة والتمثيلات المقصيّة؟
من هذه الفرضية النقدية الجريئة، ينطلق الناقد والأكاديمي الأردني الدكتور ليث سعيد الرواجفة في كتابه الأخير “شعرية النَّسق الروائي”، ليقدم مشروعا تفكيكيا يقرأ الرواية بوصفها حقلا ثقافيا تتصارع داخله قوى رمزية خفية. في هذا الاشتغال، يرصد الرواجفة كيف تُنتج الأنساق الثقافية خطابها بهدوء، وكيف تعيد تشكيل وعينا من داخل الظل، بعيدا عن ضوء المركز.
وفي قلب هذا المشروع، يطرح مفهومه اللافت عن “شعرية النسق الدميم”، كاشفا عن جماليات بديلة تنبثق من الهشاشة، والاغتراب، والانكسار، في مواجهة نماذج الجمال التقليدية.
والرواجفة هو ناقد وباحث أكاديمي أردني، متخصص في الأدب العربي الحديث ونقده، حاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الهاشمية، وكان الأول على دفعته، ونال جائزة أفضل أطروحة دكتوراه عن دراسته الموسومة بـ(العمى والبصيرة في نقد ما بعد الحداثة: دراسة تفكيكية في النقد العربي المعاصر).
اشتغل في أبحاثه على مقاربات نسقية وثقافية للأدب العربي، واهتم بتحليل الأنساق المضمرة وتمثيلات الهوية والسلطة والهوامش النصّية من منظور يستند إلى البصيرة النقدية ويتقاطع مع حقول معرفية متعددة.
في هذا الحوار، تغوص الجزيرة نت مع الدكتور ليث الرواجفة في أعماق مشروعه النقدي، لتسأله عن كيفية الإنصات لهذه الهوامش دون السقوط في فخ سلطة جديدة، وعن معنى حضور “القبح” كاستجابة سردية لعطب عميق في البنية الثقافية العربية، وعن مدى صلاحية المرجعيات النقدية الكبرى في تفكيك سردنا المعاصر.
-
في كتابكم، تشيرون إلى “الهوامش السردية المعتمة” كمواقع تُنتج فيها الأنساق الثقافية خطابها بهدوء. كيف يمكن للناقد أن يُنصت لهذه الهوامش دون أن يُعيد إنتاج مركزية سلطوية جديدة باسم الكشف والتفكيك؟
تُحيل “الهوامش السردية المعتمة” إلى تلك المواضع النصية التي لا تتصدر واجهة الحكاية، ولا تتكشّف في أنماط الشخصيات الرئيسة أو الصيغ الخطابية الظاهرة، إذ تتوارى هذه الهوامش خلف التفاصيل المهملة، والانزياحات الأسلوبية، والفراغات الدلالية التي تُظهر نفسها بوصفها عناصر ذات وظيفة غير واضحة، إلا أن طاقتها التأويلية تتنامى في الظل، وتُنتج إمكانا سرديا مضمرا يتسلل خارج خط الهيمنة النصية ويعيد بناء المعنى بطرائق خفية ومتداخلة.
وبفضل هذه الهوامش، تُراكم الأنساق الثقافية خطابها الأكثر فاعلية، حيث تعمل عبر المسكوت عنه، وطرائق التحييد، وإستراتيجيات التسلل الرمزي على إحياء حركة دلالية خفية، وتنهض بوظيفة إنتاجية تشتغل داخل طبقات المعنى المُرجأ، حيث تُستبطن الأنساق الثقافية في صيغ غير مباشرة، وتُعاد صياغة السلطة من خلال ما يتوارى خلف النص الظاهر ويُؤجِّل التصريح مما يحيي النص مع كل قراءة جديدة.
الإنصات لهذه الهوامش يقتضي من الناقد أن يعيد النظر في موقعه التأويلي ذاته، وأن يتحرر من وهم “التمكن النصي”، فالنقد الذي يتوهم موقعا خارجيا أو امتيازا تأويليا مستقلا سرعان ما يُخضع النص لإملاءات منهجه، ويُعيد إنتاج المعنى وفق خرائط مسبقة تتماهى مع السلطة أكثر مما تُفككها، ويُقنن حركة المعنى باسم التحليل أو التفكيك. وتتأسس القراءة المتحررة على التوجس من الفهم الكامل، وعلى مساءلة ذات الناقد قبل مساءلة بنية النص، وعلى الالتفات إلى ما يظل عالقا في الحواف: ذلك الذي يتردد بين الإشارة والإمحاء، وبين الحضور والغياب.
إنّ الإنصات إلى الهوامش السردية المعتمة يقتضي من الناقد أن يتعامل معها بوصفها مواقع تُنتج فيها الأنساق الثقافية خطابها بأدوات خفية، دون أن يُسقط عليها معنى جاهزا أو يُعيد تشكيلها وفق منطق تفسير سلطوي.
ويتطلب هذا الإنصات وعيا نقديا ببنية الخطاب وآليات اشتغاله، مع انتباه دائم لموقع الناقد داخل البنية الثقافية ذاتها، بما يُجنّبه تحويل الهامش إلى امتداد لمركز جديد، فالناقد الثقافي يرصد حركة المعنى داخل الهوامش بوصفها مناطق صراع رمزي، تتقاطع فيها السلطة والمقاومة، ويتعامل معها كجزء من حقل ثقافي متشابك لا يُختزل في ثنائية المركز والهامش، بل يتكشّف عبر شبكة من العلاقات التي تستدعي مساءلة مستمرة لحدود الفهم وأدوات التحليل.

-
تطرحون مفهوم “شعرية النسق الدميم” بوصفه تمثيلا للهشاشة والاغتراب. كيف تفسرون حضور هذا النسق في الرواية العربية المعاصرة؟ وهل هو تعبير جمالي عن الأزمة، أم استجابة سردية لعطب عميق في البنية الثقافية العربية؟
ينطلق مفهوم “شعرية النسق الدميم” من مساءلة البنى الجمالية التي طالما ارتبطت بمفاهيم (الانسجام، والنقاء، والتوازن)، والتحول إلى الاشتغال على تفكيك التصوّرات المألوفة للجمال، فيقترح جماليات بديلة تنبثق من (التشظي، والتوتر، والانكسار)، حيث يتكوّن المعنى من داخل الفوضى بدلا من الانسجام. ويشتغل هذا النسق على تحويل مظاهر القبح، والانحراف، والتشوّه إلى عناصر سردية فاعلة قادرة على إنتاج المعنى من خارج النماذج المستقرة. فكل ما كان يُنظر إليه بوصفه نقصا أو خللا، يتحول إلى بنية دلالية مضمرة تحمل طاقتها التعبيرية الخاصة، وتُحدث أثرا جماليا ينبع من انكساره لا من اكتماله.
يظهر “النسق الدميم” في الغالب ضمن نصوص تُجسّد هشاشة الإنسان المعاصر، وتُبرز اغترابه عن ذاته، ومجتمعه، وتاريخه. فينخرط هذا النسق بإعادة تشكيل صورة الإنسان من خلال تفكيك النموذج المثالي للذات، واستحضار تمثيلات الهشاشة والانهيار والعجز بما يكشف البنى الرمزية التي تنتج الهُوية في سياقات مأزومة ومتصدعة. وجدير بالذكر أن الهشاشة تتجاوز تمثيل الشخصيات، وتمتد إلى اللغة السردية ذاتها، حيث تتكسر البنى التقليدية، وتنهار الحبكات المحكمة، وتتبعثر الأصوات، وتفقد المرجعيات قدرتها على تثبيت المعنى أو توجيهه.
يمكن تفسير حضور هذا النسق في الرواية العربية المعاصرة بسبب التحوّل الواسع في خطابها وبنيتها السردية، إذ لم تعد تسعى إلى تقديم العالم عبر نماذج البطولات أو البنى المتماسكة، وإنما باتت تنحاز إلى سرديات التشظي والتفكك. ويعود ذلك إلى تفاقم الأسئلة الوجودية والسياسية والاجتماعية في السياق العربي، حيث بات القبح أحد تجليات الواقع وليس مجرد اختلال جمالي.
وقد أصبحت الرواية العربية في السياق الراهن أكثر ميلا إلى كشف العطب بدل الانشغال بالتجميل، واتجهت إلى إبراز التصدع والتوتر بوصفهما أدوات مقاومة للصيغ الجاهزة ومساءلة للأنماط السردية المستقرة دون أن تنغلق على خطاب تشاؤمي أو نزعة عدميّة. ومن ثم، فإن شعرية النسق الدميم تمثل انزياحا جماليا وفنيا، وتعبّر عن تحوّل في وظيفة السرد ذاتها، نحو مساءلة الثقافة من الداخل.
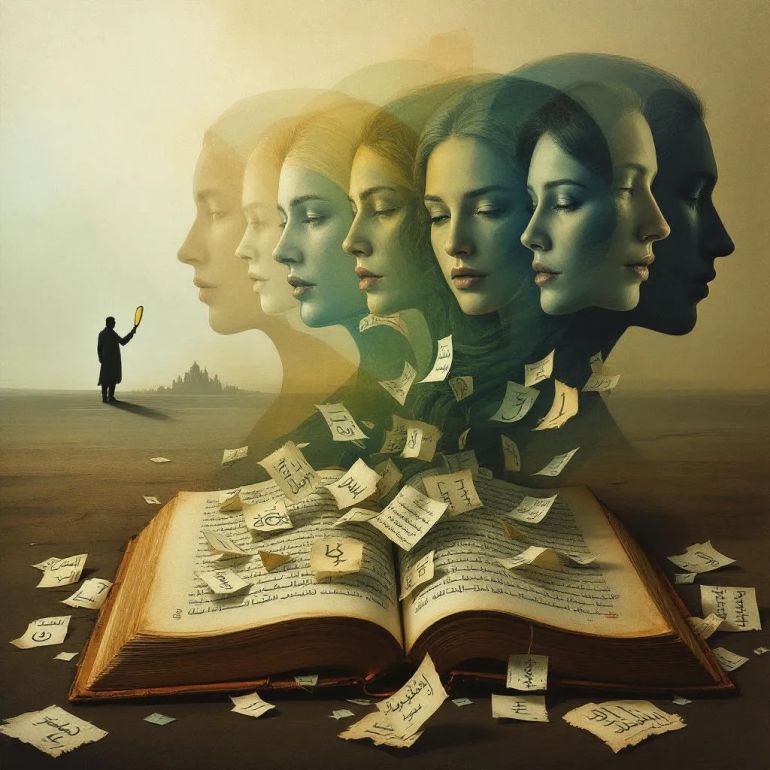
-
انطلقت دراستكم من مرجعيات ثلاث: الكلاسيكية، والحداثية، وما بعد الحداثة، باعتبارها أنظمة دلالية. إلى أي مدى لا تزال هذه المرجعيات صالحة اليوم لتفكيك السرد العربي؟ وهل ترون أننا بحاجة إلى مرجعيات نسقية جديدة تنبع من الهامش الثقافي العربي نفسه لا من استيراد المفاهيم؟
لم تنطلق دراستي من المرجعيات الكلاسيكية أو الحداثية أو ما بعد الحداثة بوصفها قواعد تحليل أو أطرا نقدية مسقطة على النصوص، ولكن تمّ معالجتها ضمن الإطار النظري للدراسة باعتبارها أنظمة دلالية تُنتج تصوّرات سردية مختلفة حول الذات، والمجتمع، والتاريخ، والهُوية. هذا التصنيف مكّنني من تتبّع تحوّلات النسق الروائي العربي من البنية المستقرة إلى البنية المتشظّية، عبر تحليل علاقة الرواية بالتراث، وبالهوية، وبأشكال التشكيل الجمالي المختلفة، دون أن يكون الهدف تأكيد صلاحية هذه المرجعيات أو التماهي معها.
المرجعيات الثلاث لا تزال حاضرة في العمق التركيبي للسرد العربي، وتعمل كمجالات دلالية متداخلة تُعيد تشكيل حضورها داخل النص عبر أنماط سردية متجددة تتجاوز التصنيف الزمني أو المرحلي، وتُظهر تراكب المرجعيات داخل البنية نفسها. كما أن السرد العربي لا يتحرك ضمن خط زمني مستقيم يُغادر مرجعية ليحلّ في أخرى، ولكنه يعيد الحوار معها جميعا، حيث تتجاور في النص الواحد -أحيانا- عناصر من النسق الكلاسيكي مع طفرات حداثية أو انزياحات ما بعد حداثية.
لذلك، تُسهم هذه المرجعيات في تشكيل الوعي السردي العربي، وتبقى حاضرة في خلفيات القراءة والتحليل، إلا أن تفكيك تعقيدات السرد المعاصر يتطلّب إعادة تأويلها ضمن سياق ثقافي وتاريخي ينبثق من خصوصية التجربة العربية، بما يسمح ببلورة أدوات قرائية نابعة من الداخل، وقادرة على فهم التحولات النصية بوصفها انعكاسا لأسئلة محلية لا لتاريخ مفاهيمي مستورد.
النقد الثقافي العربي بحاجة ماسّة إلى إعادة تأطير أدواته ومفاهيمه استنادا إلى البنية الثقافية الخاصة به، انطلاقا من مساءلة المرجعيات الغربية وإزاحتها عن موقع الاحتكار، وفتح المجال لمرجعيات تنبثق من داخل السياق العربي وتعبّر عن تحوّلاته وخطاباته الخاصة. إنّ ما يسمى بالهامش الثقافي قادر على إنتاج معرفة بديلة، والكشف في الوقت ذاته عن آليات تشكّل السلطة والمعنى داخل سياقات مغايرة، حيث تتكون الدلالة من خلال تفاعل الهامش مع البنى المهيمنة واتجاهات تمثيلها.
وإن كان هناك حاجة إلى مرجعيات نسقية جديدة ينبغي أن تنبع من قراءة الأنساق المتجذرة في الخطاب العربي بما فيها من تحولات في اللغة، والهوية، والتمثيل، وتوتر العلاقة بين الموروث والمعاصر. كما أن هذه المرجعيات لا تُبنى عبر التبنّي أو الاستيراد، وإنما عبر تفكيك الداخل الثقافي نفسه، والإنصات إلى ما ينتجه من خطابات وثيمات وصور سردية غير نمطية.
وعلى سبيل الختام، إن الممارسة النقدية اليوم لم تعد شأنا تقنيا يُعنى بتوصيف الظواهر أو تصنيف الاتجاهات والأنماط، إنها ممارسة مشروطة بقدرتها على إنتاج وعي ثقافي يُنصت لما يتغيّر في النص وفي العالم معا. وهو ما ينسجم مع الرواية العربية المعاصرة التي قدمت نفسها ضمن حركة نسقية أعادت تشكيل المعنى وفككت تمثيلاته من الداخل، وتجاوزت المرجعيات الجاهزة والأنماط المسبقة من خلال سرد أنتج أسئلته انطلاقا من التجربة ذاتها، وليس من تصورات مفروضة عليها.
ومن هنا، جاءت هذه الدراسة بوصفها محاولة لتوسيع أفق المقاربة النقدية، والتفكير في السرد باعتباره حقلا ثقافيا تتقاطع فيه البنى الجمالية مع اشتغالات الوعي، وتتكشّف فيه التوترات الكامنة بين المركز والهامش، والانسجام والتشظي. فتجاوزت هذه المقاربة بناء نموذج تأويلي مغلق، وسعت إلى مساءلة أشكال التمثيل، والتقاط ما يتشكل في الهامش السردي بوصفه موقعا منتجا للمعنى.
إنّ ما تنتجه الرواية اليوم يتجاوز حدود الحكاية إلى طرح أسئلة كبرى حول الهوية، والسلطة، واللغة، وهي أسئلة تُحتَضن داخل الخطاب، وتُفكَّك عبر القراءة، بما يجعل من النقد الثقافي أفقا مفتوحا للتفكير في الذات العربية وهي تكتب واقعها بأدوات سردية مشحونة بالتوترات، ومنفتحة على أسئلة الواقع وتصدعاته.
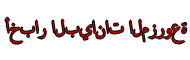 أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.



