منذ توليها تدبير الشأن العام صيف عام 2021، رفعت الحكومة شعارات “كبيرة” وتطلعات “حالمة” وتعهدت بتخليص المغاربة من أزمات عقود من “التدبير الفاشل” للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، قبل أن تتضح ملامح مقاربة تدبيرية، جديدة قديمة، لـ”حكومة الكفاءات” في تنزيل أوراش مهمة واستراتيجية بالاعتماد على جمعيات المجتمع المدني وإطلاق اليد لها في أجرأة سياسات عمومية في التعليم والصحة والفلاحة والتشغيل.
وبحكم إنهاك البطالة لفئة عريضة من شباب المغرب، قادت الحكومة في سنتها الأولى برنامجا، قالت إنه ذي طموحٍ عالٍ في تخفيض نسبة “الشوماج” وإدماج آلاف العاطلين في سوق الشغل عبر ما عُرِف ببرنامج “أوراش”. لم يختلف حينها أحد حول أهمية وقيمة الفكرة والبرنامج، لكن الانتقادات طالت أسلوب تدبير وتنزيل مضامينه، حيث فُسح المجال أمام المنخرطين في جمعيات المجتمع المدني التي يتم انتقاؤها للاستفادة من الدعم المخصص، ما أثار شكوك في شفافية ونزاهة اختيار المستفيدين وطرح سؤالاً كبيراً في تلك المرحلة “هل تواجه الحكومة أزمة البطالة بالاستناد على الجمعيات؟”.
ولم تتوقف المقاربة التفويضية للجمعيات من طرف الحكومة في تدبير عدد من الأوراش الكبرى عند برنامج أوراش وإنما امتدت لتشمل ورشاً لا يقل أهميةً عن التشغيل ومواجهة شبح البطالة بالاعتماد على الجمعيات في تدبير أقسام التعليم الأولي، والتي أعطت نسبياً نتائج إيجابية في رهان التعميم، لكن سؤال الجودة لا يزال رهين تقييم التجربة. وللإشارة، فإن تفويض تدبير التعليم الاولي للجمعيات ليس من إبداع “حكومة أخنوش” بقدر ما هو استمرار لنهج الحكومات السابقة في معاكسة صريحة لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي لطالما ذكَّر بضرور دمج التعليم الأولي في التعليم الإبتدائي وتوحيد إدارتهما في سلك واحد.
ولسوف يترسخ هذا التوجه الذي تُدبر به الحكومة أوراشا مهمةً عندما قررت وزارة الفلاحة أن تمنح لجمعية مهنية في تربية الأغنام والماعز مسؤولية الإشراف على الإحصاء الوطني الماشية وكأنها محطة عادية لا ترتبط بأزمة “النقص الحاد” التي يعيشها القطيع الوطني، إلى درجة أن منتقدي هذا النهج التدبيري ذهبوا إلى التساءل عن “الجدوى من وجود وزارة للفلاحة إذا كانت غير قادرة على إحصاء قطيعها”.
ومن حيث المنطلق الدستوري، فإن إجراءات الحكومة لا تتعارض مع النص الدستوري الذي عزز من مكانة المجتمع المدني في المساهمة في صناعة القرار العمومي خصوصا في الفقرة الثالثة من فصله الثاني عشر الذي أكد: “تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.
وإذا كانت الوثيقة الدستورية لا تعارض هذا المنطق الذي تدبر به الحكومات أوراش كبرى، فإن واقع الفعل الجمعوي وكفاءة أصحابه يطرح نقاط استفهام كبيرة حول فعالية رهان الحكومة على توسيع مشاركة الجمعيات في التدبير العمومي، إذا أن النسبة الساحقة من هذه الهيئات تعمل بمنطق تطوعي، ولا تشغل سوى بضعة آلاف، ما يضعف قدرتها على تنفيذ أوراش معقدة كالتي كلفت بها.
ويطرح مراقبو هذا النهج التدبيري في تنزيل أوراش اجتماعية مهمة بالاعتماد على الجمعيات، وفي مقدمتها التعليم الأولي والتشغيل، مسألة المسؤولية السياسية والقانونية في حال فشل هذه الجمعيات في تحقيق الغايات المرجوة من بعض السياسات العمومية، متهمين الحكومة بـ”التهرب” من مسؤوليتها و”تلفيق” أي فشل إلى مكونات المجتمع المدني.
مبدئياً، لا مشكلة في إشراك الجمعيات
ياسين اعليا، دكتور باحث في الاقتصاد وناشط مدني، قال إن “إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير هذه الأوراش الكبرى لا يتنافى، مبدئياً، مع المقاربة التشاركية في إنتاج الخدمة العمومية”، مبرزاً أنه “من الناحية الاقتصادية، فمكونات المجتمع المدني تتقاطع، في غاياتها، مع أهداف الإدارة العمومية في الاستجابة لحاجيات المواطنين وتوفير ما يلزم من خدمات اجتماعية واقتصادية بدون مقابل”.
وأضاف اعليا، في حديثه مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا المبدأ يستمد قوته من كون المجتمع المدني لا يشتغل بالمنطق الربحي أو اقتصادي محض بل يحركه الجانب التطوعي”، مُسجلاً أنه “لا بد من التفكير في توسيع حضور ودعم الجمعيات المدنية في المغرب وليس إضعافها”.
وفي هذا الصدد، استحضر اعليا تجربة فرنسا في التأسيس لمجتمع مدني قوي ومشاركة في التدبير العمومي، مشيراً إلى أنه يساهم بقرابة 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون و800 ألف شخص، وهذا ما نحن بعيدين عنه بشكل كبير في المغرب حيث لا تتجاوز مساهمة النسيج الجمعوي نسبة 1 في المئة.
ولم يجد المهتم بقضايا الاقتصاد والاقتصاد التضامني مانعاً، من منطلق مبدأ التشارك في التدبير، في أن تناط بمكونات المجتمع المدني مثل هذه المهام والمسؤوليات وفي حدود إمكانياتها، مشيراً إلى أن “عدد من البرامج نجحت بفضل جهود هذه الجمعيات وعلى رأسها التعليم غير الرسمي والصحة والرياضة والثقافة وعدد من المجالات.
وأوضح الخبير عينه أن “اعتماد الحكومة على الجمعيات من أجل تنزيل بعض البرامج أو السياسات العمومية لا يعني بالضرورة استقالتها أو امتناعها عن القيام بمهامها الأساسية بحكم المسؤولية السياسية للقطاعات الحكومية أمام المواطن المغربي وليس هذه الجمعيات”، مشددا على أن عدم إنتاج الخدمة العمومية يضع المسؤولية في رقبة الحكومة أولاً”.
وسجل المصدر ذاته أن “تكليف الجمعيات بمثل هذه المهمات هو توسيع لمجال المسؤولية ولمجال اشتغال المجتمع المدني من خلال تحميله جانباً من المسؤولية في التنزيل وخلق الثروة عوض تركيز جميع المسؤوليات التدبيرية في يد السلطة المركزية ممثل في الحكومة أو عبر سلطاتها الفرعية في الجهات والأقاليم”، مبرزاً أن “هذا الأسلوب التدبيري يخفف العبء على الحكومة لكن في المغرب يطرح إشكالية الشفافية وعلاقات الانتماءات والولاءات في مثل هذه التفويضات”.
وعلى الرغم من اعتباره، من حيث المبدأ، إجراءً سليماً، استدرك المتحدث ذاته بالقول إن إطلاق اليد للجمعيات في تدبير أوراش كبرى مثل التشغيل والتعليم الأولى وتكليفها بإحصاء الماشية، وفي السياق الحالي، قد يطرح العديد من الإشكاليات المرتبطة بنوعية الأنشطة وطبيعة الرقابة الممارسة على أنشطتها ودرجة تكوين أعضائها ونوعية التكوين الذي تستفيد منه هذه الجمعيات.
وعند نقل “مدار21” الإلكترونية لسؤال مشروعية هذا النهج التدبيري للسياسات العمومية وتأثيره على مردودية لبرامج الحكومية على العضو والباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، رشيد أوراز، قال إن “الحكم على هذه التجربة هل هي سلبية أم إيجابية يتوقف على من ينفذ وماذا يحقق كنتائج، كما يتوقف أيضا على العلاقة بين من يفوض ومن يفوض له الأمر، وهل هناك علاقة مصلحة وتضارب مصالح؟”، مشددا على أنه “على العموم في مجتمعات مثل المجتمع المغربي، يتسم هذا النوع من البرامج بتداخل المصالح الشخصية مع هذه البرامج، ما يفتح المجال للفساد وتبذير المال العام”.
مسؤوليةٌ يحدُّها نقص الكفاءة
وفي علاقة بسؤال الكفاءة لدى الفاعل المدني المغربي في ارتباطه بتنزيل هذه البرامج الاجتماعية المهمة، سجل اعليا “تُشغِّل الجمعيات في المغرب عدداً محدوداً جداً لا يتعدى بضعة آلاف من المواطنين”، مشيراً إلى أن “أغلبهم يشتغل بالمنطق التطوعي وبالتالي لا تكون هناك إلزامية المردودية من طرف المتطوع مما قد يحد من نجاح وإنتاجية هذه الأوراش الكبرى التي بنت على بعضها الحكومة برنامجها الحكومي ويضعف أثرها على السياسات العمومية ويقلص هامش الإتقان”.
وضمن أوجه القصور التي بدت للخبير الاقتصادي أنها مؤثرة في أداء الجمعيات لهذه المهام التي أوكلت لها مسألة العدد الكبير لجمعيات المجتمع المدني، الذي تجاوز 200 ألف، وهو ما يمتحن استقطابها للكفاءات والبروفايلات الجمعوية القادرة على حمل هذه المسؤولية الكبيرة.
وفي حديثه عن تحدي الكفاءة ورهان توفر الجمعيات على البروفايلات القادرة على إنجاح هذه البرامج، تساءل اعليا “كيف للجمعيات أن ترفع تحدي الكفاءة في الوقت الذي لا يتوفر فيه النسيج المقاولاتي على الكفاءات اللازمة على الرغم من سياسات الحكومات لدعم المقاولات؟”.
وشدد اعليا على أنه “من الصعب أن تنجح الجمعيات في ما فشلت فيه المقاولات التي تؤدي أجوراً لأجراءها، فما بالك بجمعيات تعمل بشكل تطوعي أو تؤدي أجور هزيلة للعاملين فيها”، مبرزاً أن “الشروط الحالية تجعل من تفوق المجتمع المدني في المساهمة في تنزيل هذه السياسات أمراً صعباً جداً”.
أوراز، وافق نفس رأس الخبير الاقتصادي اعليا حينما قال إن “الجواب عن كفاءة وقدرة هذه الجمعيات في تنزيل هذه الأوراش واضح، وهو لا”، مشيراً إلى أن “الدولة نفسها لا تتوفر على موارد بشرية مؤهلة لتسد النقص، فما بالك بالمجتمع المدني الذي يعاني من ضعف على مستويات عدة؛ التكوين والتدبير والموارد والشفافية؟”.
من يساءل عند الفشل؟
مراقبو هذا النهج التدبيري القائم على توسيع مشاركة الفاعل المدني في التدبير العمومي وإنتاج الخدمة العمومية بالاعتماد على الجمعيات، وفي مقدمتها التعليم الأولي والتشغيل، يخضعون التجربة لامتحان المسؤولية السياسية والقانونية في حال فشل هذه الجمعيات في تحقيق الغايات المرجوة من بعض السياسات العمومية، معتبرا أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون محاولة لـ”التهرب من مسؤوليتها عند أي فشل”.
واتفق أوراز مع المشككين في نوايا الحكومة عند تفويض تدبير بعض الأوراش الكبرى للجمعيات بالقول إنه “مع الأسف، فإنه عند كل فشل في تنزيل البرامج والسياسات العمومية يتم إلقاء المسؤولية على الغريب”، مبرزاً أنه “أحيانا يتم تجاهل حتى الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد والفشل، فما بالك بمثل هذه المشاريع؟”.
اعليا، وفي هذا الصدد اعتبر أن هذه الجمعيات وبحكم استفادتها من الدعم العمومي من المال العام، فإنها تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات عبر المجالس الجهوية للحسابات، مستدركاً أن هذه المؤسسة الدستورية لا تكفي وحدها للرقابة وإنما لابد من تفعيل آلية مفتشيات الوزارات والتي يفترض أن تقوم بعمليات افتحاص لهذه الجمعيات، سواء في ما يتعلق بالأموال التي تتصرف فيها أو مسطرة اختيار المكلفين بهذه الأوراش.
ولم ينف المتحدث ذاته مخالفة واقع الحال لما يتم رفعه من شعارات الشفافية والمصداقية من طرف الحكومة لإضفاء الشرعية والمصداقية على هذه الأوراش، مؤكداً أن هناك الكثير من المحاباة والخروقات في تدبير هذا الورش في جميع مستوياته، وهو ما يفسد التنزيل السليم له.
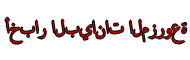 أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.



