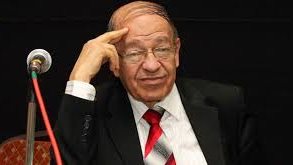نشرت في الفترة الأخيرة شخصيات سياسية وأكاديمية ومدنية نصوصًا من خارج الصندوق أكدوا فيها، كل حسب خلفيته ورؤيته، حاجة تونس الراهنة إلى طي صفحة الماضي القائم على التنافي والإقصاء والفرز الأيديولوجي الحاد، وإلى فتح عهد جديد قوامه الاعتراف المتبادل بعيدًا عن الطهورية والشيطنة، والحوار بدل التنافي والقطيعة؛ من أجل بناء تعاقد سياسي يقوم على مبادئ مشتركة، تؤسّس لحالة وطنية جديدة.
أثارت هذه النصوص جدلًا بين من ثمّنها ورأى فيها أفقًا جديدة للعملية السياسية، وبين من شكّك في نوايا بعض أصحابها لسابق أدوارهم السلبية في إعاقة الانتقال الديمقراطي، وبين من يرى أن شروط نجاحها غير متوفرة بالقدر الكافي.
السؤال: هل تمثل هذه النصوص مدخلًا لإطلاق ديناميكية جديدة داخل الفضاء العام التونسي، يمكن أن تفضي إلى قيام ثقافة سياسية جديدة تعطي أفقًا ومعنى جديدين للعملية السياسية؟
للتذكير بداية، ليست هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها دعوات للحوار، بل تكاد تكون الدعوة للحوار بين مختلف الفاعلين في الشأن العام ثابتًا في كل تقدير موقف ينتهي به التحليل إلى تأكيد تكلّس الفضاء العام، وانسداد آفاقه في ظلّ ما تمارسه سلطة الأمر الواقع من تجريف متواصل للحياة السياسية، انتهى بقتل السياسة وتهميش الأجسام الوسيطة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية.
إرث ثقيل رغم تعدد المحاولات
بقيت الحياة السياسية في تونس محكومة على مدار العقود الخمسين الأخيرة بحالة استقطاب “حاد” بين مختلف العائلات السياسية، وبين روافد كل عائلة منها تقريبًا، مع اختلاف في الدرجة من عائلة إلى أخرى، وهو ما يفسّر إلى حدّ ما كثرة الانشقاقات الحزبية، وتوالد بعضها من بعض.
كان الفضاء الجامعي والحراك الطلابي أهمّ فضاء تجلّى فيه الاستقطاب بين التيارات السياسية والنقابية الطلابية من يساريين وإسلاميين وقوميين، ما جعل العلاقات بينها صفرية وعنيفة ودموية أحيانًا. رغم أن الجميع تقريبًا كان يرفع شعار الحرية، لم يكن أغلب هذه الأطراف يجد حرجًا في استثناء من يعتبرونهم “أعداءهم الرئيسيين”.
بقي الحال في خطّه العام على ما هو عليه زمن الرئيسين؛ بورقيبة، وبن علي حتى قيام الثورة. لم يكسر هذا السمت العام غير أربعة أحداث مهمة في التاريخ السياسي المعاصر لتونس:
الأول، العرض السياسي الذي قدّمته حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة لاحقًا) في وثيقتها التأسيسية خلال ندوتها الصحفية بمناسبة إعلان دخولها العمل السياسي الحزبي العلني في السادس من يونيو/ تموز 1981.
من أبرز ما جاء في هذه الوثيقة “الدفاع عن الحريات العامة والخاصة، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والمعتقد، الانفتاح على القوى الوطنية والدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية، والعمل المشترك من أجل بناء تونس جديدة قائمة على العدالة والحرية”.
الثاني؛ هو إطلاق طلبة الاتجاه الإسلامي (الرافد الطلابي لحركة الاتجاه الإسلامي) “الميثاق الطلابي الموحد” في نوفمبر/ تشرين الثاني 1984 كمبادرة تعيد حرية القرار لعموم الطلاب؛ لتحديد ما يرونه خيارًا مناسبًا لحلّ إشكالية التمثيل النقابي الطلابي.
كان الميثاق ترجمة للفكرة السياسية للطلاب الإسلاميين التي تقوم على أن الحوار المفتوح للجميع هو السبيل الديمقراطي لبلورة خيار طلابي أغلبي حرّ دون وصاية من أحد. رفضت بقية التيارات السياسية الطلابية المبادرة، ومضى بعضهم لاحقًا في بناء هيكل نقابي آخر استنادًا لقراءة آحادية لتاريخ العمل النقابي الطلابي.
جاءت فكرة “الميثاق الطلابي الموحّد” امتدادًا لشعار “نريد الحرية في الجامعة والبلاد” الذي رفعه الطلبة الإسلاميون أواخر سبعينيات القرن الماضي، في ظلّ هيمنة اليسار الماركسي على العمل الطلابي، والنقابي، والفضاء الجامعي عمومًا، وفي الوقت الذي كان فيه التيار الإسلامي الناشئ في البلاد يواجه التضييق والقمع من نظام الحكم.
الحدث الثالث هو حراك 18 أكتوبر/ تشربن الأول 2005 الذي بدأ تحركًا سياسيًا ومدنيًا (إضراب جوع) حول مطالب سياسية وحقوقية، وشارك فيه ممثلون عن أطياف مختلفة من المعارضة التونسية من إسلاميين ويساريين وقوميين وليبراليين.
تطور هذا الحراك في ديسمبر/ كانون الأول 2005 إلى “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” كفضاء للحوار والتداول بين الإسلاميين والعلمانيين صدر عنه “بيان 18 أكتوبر 2005” مثّل وثيقة سياسية هامة وتحوّلًا فارقًا في تاريخ المعارضة التونسية جمع لأول مرة الإسلاميين والعلمانيين حول مطالب مشتركة من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كما أكد البيان على ضرورة “وحدة العمل حول الحد الأدنى من الحريات”، وفتح حوار وطني شامل يفضي إلى بلورة “عهد ديمقراطي” يضمن المساواة والحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات.
مثّلت “هيئة 18 أكتوبر” لأول مرة منصة لحوار وطني جمع أطيافًا مختلفة من تيارات سياسية ومدنية، حيث ساهم في تعزيز الوعي السياسي، وتعميق النقاش حول قضايا الديمقراطية والحريات والحقوق في تونس، وشكّل خطوة هامة نحو الوحدة والتعاون في مواجهة الاستبداد وقتها.
الفرصة المهدورة
في الوقت الذي كان يُفترض فيه البناء على حصائل “هيئة 18 أكتوبر” وخاصة فكرة العهد الديمقراطي لإدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، عاد الاستقطاب الأيديولوجي بعد الثورة مباشرة وبمنسوب أعلى فاق كل الفترات السابقة، استحكم تقريبًا كامل عشرية الانتقال الديمقراطي (2011-2021).
كانت فكرة تأسيس “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي”، برئاسة أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور فكرة صحيحة باعتبارها منصة للحوار والتداول لضبط آليات إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، حيث ضمّت ممثلي الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات، وشخصيات مستقلة، وممثلين عن الشباب والمرأة.
غير أن مناخات اللجنة كانت مشحونة بالاستقطاب الأيديولوجي بين من أعلنوا أنفسهم ذاتيًا حداثيين بالطبيعة، وبين تيار الهوية، ومنه أساسًا حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.
جاءت حصائل هذه اللجنة من جنس مناخاتها وموازين القوى داخلها موجّهة بخلفية أيديولوجية أكّدها رئيس اللجنة لاحقًا عندما قال إنهم “فعلوا كل شيء” حتى تكون مراسيم إدارة المرحلة الانتقالية وقوانينها مقيّدة لحركة النهضة بحيث “تحرمها” من الاستفادة من حجمها الانتخابي في ممارسة الحكم، مقابل ضمانات لتمكين الأحزاب العلمانية من المشاركة في الحكم، بل والتأثير فيه رغم تواضع حجمها الشعبي والانتخابي.
بالنتيجة، ساهمت هذه اللجنة في إفراغ فكرة التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية من خلال زرع ألغام لم تلبث أن انفجرت لاحقًا في وجه الحكام الجدد، فساهمت بذلك في إعاقة التجربة، ومهّدت الطريق لانقلاب يوليو/ تموز 2021 للإجهاز عليها ثم تفكيكها.
طبعت نتائج الهيئة مجمل العملية السياسية طوال العشرية السابقة بتكريس ديناميكيات سلبية فرّقت ولم تجمّع، عمّقت الاستقطاب وخلقت انقسامًا حادّا بين التونسيين، بين من يعتبرون أنفسهم مواطنين من درجة أولى، أمناء على تاريخ تونس ومستقبلها وعلى نمطها المجتمعي الحداثي، وبين تيار الهوية ومحوره حركة النهضة الإسلامية التي فعلت كل شيء لإثبات حق من تمثّلهم من التونسيين في مواطنة كاملة تجعلهم على قدم المساواة مع الجميع دون إقصاء أو تهميش بما يعيد التوازن للمشهد العام.
الثورة المغدورة
مثلما كانت الهيئة فرصة مهدورة، كانت الثورة مغدورة من الداخل والخارج. غدر بها غالب النخب يوم أصرّوا على أن يسلكوا طريقًا غير طريق الحوار والتعايش والاعتراف المتبادل، فاتحين بذلك البلاد على جحيم الإقصاء والفرز على الهوية، والاستقطاب الأيديولوجي الحاد.
لم تكن العملية السياسية بعد الثورة – مثلما كان متوقعًا- استئنافًا لما بدأته المعارضة في “هيئة 18 أكتوبر” وبناء على مخرجاتها، بقدر ما كانت استصحابًا لما حصل في هيئة بن عاشور، حيث تنكّر أغلب العلمانيين للحوار والالتقاء مع مخالفيهم، وخاصة حركة النهضة.
جاءت حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 الأولى، من حيث نسبة التصويت (37.04%) وعدد المقاعد (89 مقعدًا) بفارق 60 مقعدًا و(28.33%) نقطة في نسبة التصويت عن الثاني في الترتيب.
مع ذلك، بادرت حركة النهضة بدعوة كل القوى السياسية من مختلف العائلات لبناء “كتلة تاريخية” تتشارك في الحكومة والمجلس للقيام بأعباء المرحلة الانتقالية. رفض أغلب الأطراف، ومنهم من كانوا شركاء لها في “هيئة 18 أكتوبر”، وأعلنوا أنهم اختاروا موقع المعارضة، فيما قبل دعوتها حزبا التكتل من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية، وهما حزبان علمانيان.
مرّة أخرى، تعبّر حركة النهضة عن ثوابت هويتها السياسية المتأصلة في مرجعيتها الإسلامية، وهي الاعتراف بحق الاختلاف وإدارته بأدوات ديمقراطية لبناء بيئة سياسية نظيفة خالية من الإقصاء والتنافي يتنافس فيها الجميع من أجل خدمة الشعب صاحب السيادة.
ومرة أخرى تبدو الهوّة “سحيقة” والمسافة بعيدة بين عرض سياسي يدعو إلى التقاء وطني حول عهد ديمقراطي يسع كل من يساهم فيه ويقبل به، وعرض نقيض له بضاعته التقسيم والاستقطاب والإقصاء والوصم بناء على إعلان من جانب واحد بأن أصحابه فقط هم الحداثيون، التقدميون والديمقراطيون.
رغم صعوبة تجربة الترويكا وتصدّعها نتيجة تفجّر الخلاف داخلها حول طريقة إدارة الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد بعد الاغتيالين السياسيين، واعتصام الرحيل، بقيت حركة النهضة وفيّة لهويتها السياسية وشاركت في الحوار الوطني الذي انتهى بتوافقات أمّنت عبور البلاد بسلام من أزمة مفتوحة على الفوضى إلى استقرار فتح على نفس جديد للانتقال الديمقراطي، عناوينه حكومة كفاءات، دستور توافقي، هيئة مستقلة للانتخابات، وموعد للانتخابات.
كانت حصائل الحوار الوطني مهمّة في نزع فتيل الاحتراب الأهلي بالتوافق على أجندة سياسية للمرحلة، غير أنه لم يكن تامّا ولا قابلًا للامتداد في الزمن لأكثر من محطة الانتخابات (2014)؛ لعدم اشتماله على توافق حول مبادئ وأفكار كبرى تؤسّس لعهد ديمقراطي يسع الجميع ويحترمه الجميع، رغم أن دستور 2014 التوافقي قد اشتمل على العديد منها، ولكنها بقيت غير مفعّلة.
ومع ذلك، كانت حركة النهضة وفيّة مرة أخرى لهويتها السياسية عندما مضت في توافق مع حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، انتهى سنة 2018 بتحالف النهضة مع حزب تحيا تونس المنشق عن نداء تونس برئاسة رئيس الحكومة وقتها يوسف الشاهد.
كان ذلك منعرجًا اتجهت فيه البلاد نحو أزمة متعدّدة الأبعاد والأطراف ألقت بظلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بفوز نهضة ضعيفة، والرئاسية بفوز المرشح قيس سعيد القادم من خارج المنظومة الحزبية.
عمّق انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 الأزمة وأعاد البلاد إلى الدكتاتورية وحكم الفرد، كما بدا نقيضًا لروح الثورة والانتقال الديمقراطي، وللمشروع السياسي لحركة النهضة القائم على التشاركية والفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة.
الانقلاب فرصة معلّقة
بدت النهضة وحيدة ليلة 25 يوليو/ تموز 2021 عندما وقف رئيسها ورئيس البرلمان الأستاذ راشد الغنوشي أمام برلمان تمّ غلقه بدبّابة، معلنًا دون تلعثم أن ما حصل هو انقلاب على الشرعية والديمقراطية تجب مقاومته مقاومة سياسية سلمية.
كان المزاج العام السياسي والشعبي يرى فيما حصل تصحيحًا لمسار الثورة وفرصة لإعادة ترتيب الأوضاع بدون النهضة وحلفائها.
لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت المواقف تتغير وبدأ الحزام المعارض للانقلاب يتوسع وبدأ الشارع الديمقراطي يعبّر عن رفضه الانقلاب من خلال تحركات جماهيرية نظمها “مواطنون ضد الانقلاب” الذي مثّل وقتها جوابًا صحيحًا لسؤالي المرحلة، ما العمل بتأكيد الحاجة إلى مقاومة الانقلاب، والعمل على استعادة حالة ديمقراطية، وكيف العمل بتجميع قوى ديمقراطية معتدلة في هيكل واحد رغم اختلافها؟
ظلّت فكرة تجميع قوى المعارضة الديمقراطية المعتدلة تراوح مكانها رغم تعدّد مبادرات المعارضة السياسية والمدنية للالتقاء في جبهات وائتلافات بقيت مغلقة لا تضمّ غير المتشابهين حتى استقر المشهد السياسي بعد أربع سنوات من الانقلاب على كيانات جمع بينها قهر الاستبداد والخوف من بطشه، وفرّقت بينها المعارك الأيديولوجية التاريخية، والمواقف الحادة من العشرية السابقة والرؤى للمستقبل.
في الوقت الذي كان يجب فيه على المعارضة إطلاق حوار وطني شامل والتنسيق لتوحيد جهودها لبناء حالة سياسية جديدة جاذبة ودامجة لكل القوى الديمقراطية، تواصل الإقصاء والتنافي والتمييز والوصم والشيطنة، ما جعل بعض الأصوات التي تحاول كسر هذه الأقفاص تبدو نشازًا تلقى من اللامبالاة والازدراء والتنمّر أكثر مما تلقى من الاهتمام والتثمين.
ربّما نحتاج في الحالة التونسية الراهنة التمييز بين أمرين اثنين مطلوبين: الأول، التقاء الفاعلين السياسيين الديمقراطيين حول جملة من المطالب السياسية، مثل مقاومة الانقلاب، إطلاق سراح المعتقلين، ورفض المحاكمات السياسية، وإلغاء المرسوم 54 سيئ الذكر.
هذا الالتقاء واقع عمليّا، ولكنه غير كافٍ لتغيير ميزان القوى بين السلطة والمعارضة؛ لأن محرّكه ليس أكثر من إحساس الجميع بالخوف من اشتداد قبضة الانقلاب، وهو إحساس قابل للتغير، بحيث لا يمكن اعتماده أساسًا لبناء حالة سياسية راسخة.
الثاني والأهم هو التقاء تاريخي حول تعاقد ملزم بين أنداد متساوين في المواطنة على عهد ديمقراطي يقوم على أفكار كبرى واضحة مثل الديمقراطية والحقوق والحريات والاعتراف المتبادل بدون اشتراطات، والتداول السلمي على السلطة، واحترام نتائج الصندوق.
الواضح أن الطريق إلى العهد الديمقراطي لا يزال طويلًا ودونه عوائق ومتاعب يمكن طيّها وتجاوزها إذا ما صحّ العزم من الجميع بإنجاز ثورة جديدة تكون هذه المرّة على ثقافة سياسية بالية حان وقت استبدالها بأخرى أكثر انسجامًا مع قيم الثورة والحداثة السياسية. ذلك هو قارب العبور من ضيق الانقلاب إلى سعة الحرية والديمقراطية والمواطنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
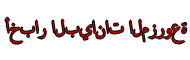 أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.